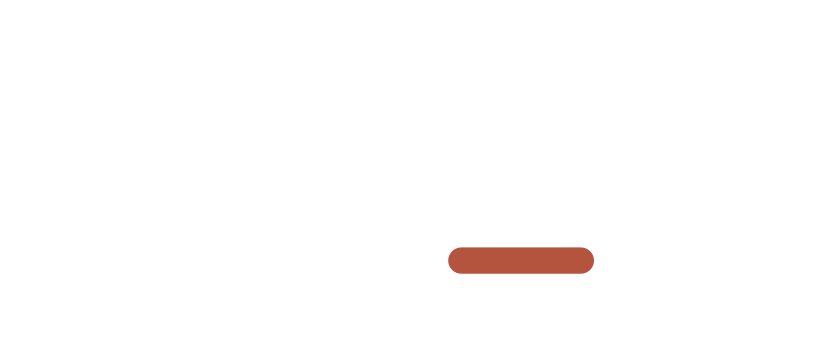إن السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم — من صناع السياسة إلى المستثمرين العاديين — لا يفضي إلى إجابة مريحة: من أين سيأتي الزلزال المالي القادم؟ الواقع أن الجواب قد أصبح شبه بديهي: إنه ليس إذا ما سيأتي، بل متى سيقع.
الاقتصاد العالمي، الذي أنهكته جولات متكررة من صدمات كبرى (كالجائحة، التضخم، أزمات الطاقة، وحروب الفائدة)، يقف الآن على مفترق طريق. أمامه ثلاث بؤرٍ زلزالية تُخشى أن تتفاعل، وتُحدث زلزالاً هائلاً بكافة معايير النظام المالي الدولي.
أول البؤر: ديون الدول الكبرى — الرُعب الكامن في القيم السيادية
الدين الياباني والأزمة المخفية وراء الين
عندما نتحدث عن ديون الدول، لا يمكن أن نغفل حالة اليابان. فالدين العام هناك تجاوز منذ زمن طويل 250٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يُعدّ من دون دليل إلى درجة تعرض الموازنة الوطنية إلى ضغوط مستدامة.
لكن المخاوف لا تقتصر على المدى البعيد؛ فهي تُترجَم اليوم في هبوط الين إلى مستويات قياسية (150–151 يناً مقابل الدولار، وربما أكثر)، ما يزيد من تكلفة خدمة الدين المحلي ويضع السلطات أمام مفترسين: التدخّل المكلف أو الصمت المريب.
ومما يزيد الطين بلّة أن بنك اليابان يُعد من أكبر الحائزين على سندات الخزانة الأميركية، وبذلك أي تحرّك مفاجئ في استراتيجياته النقدية قد يرسل موجة بيع ضخمة تضرب أسواق السندات العالمية. من طوكيو إلى وول ستريت، قد تتداعى الثقة بين ليلة وضحاها.
الدين الأمريكي: هل نُواجه تهديد تصفية السندات؟
على الطرف المقابل من المعادلة، تقبع الولايات المتحدة بمعزل زمني مخيف أمام فورة ديون وصلت إلى مستويات لم يُسجَّل لها مثيل: أكثر من 36 تريليون دولار، ومع توقعات بأن تتجاوز عتبة 40 تريليون بنهاية 2025.
هذا الرقم الهائل خلق بيئة استثنائية في سوق السندات: عائد على السندات لأجل 10 سنوات يفوق 4.5٪، وعوائد السندات لأجل 30 سنة تقترب من 5٪. وهذه الأرقام تُضفي مزيدًا من الوزن على أزمة الاستدامة المالية.
في هذا السياق، يلوح في الأفق “البيع العظيم” — أي سيناريو تقوم فيه دول كبرى (كالصين أو اليابان) بإعادة هيكلة مخصصاتها من السندات الأميركية، إما لتقليص المخاطر أو تفادي الخسائر المتوقعة. التأثير؟ هزة قوية في ثقة الأسواق عالمياً، باعتماد الدولار كملاذ عالمي وعمود فقري للنظام المالي العالمي.
كيف يلتقي هشاشا اليابان وأمريكا في نقطة الانهيار؟
قد يبدو أن الأزمة اليابانية وأزمة الدين الأميركي منفصلتان، لكن في الواقع هما عقدتان مترابطتان. إذا اضطُرَّ بنك اليابان أو الحكومة اليابانية إلى تقليص مشترياتها من السندات الأميركية — أو في أسوأ الحالات، إلى تصفيتها — فسيكون التأثير بمثابة “شرارة” لزلزال عالمي.
تضاف إلى ذلك أن أي ارتفاع في عوائد السندات الأميركية يُصعب أعباء الفوائد على الحكومات والشركات على حد سواء، مما يُفاقم الضغوط على الموازنات العامة في دول متعددة.
باختصار، هذه البؤرة الأولى قد تُشعِل الحريق الأكبر إذا اجتمعت الظروف.
ثاني البؤر: الطاقة والنفط — الشريان الذي يمكن أن ينفجر
النفط بين رسائل العرض والطلب
في قلب شبكة الطاقة العالمية يكمن النفط، الذي قد يبدو بسيطًا لكنه يحمل القدرة على قلب موازين القوى. فأسعاره تتأرجح بين سيناريوين متناقضين: ارتفاع مفاجئ أو انهيار حاد.
العوامل الدافعة للارتفاع تتجسّد في التوترات الجيوسياسية، اضطرابات الإنتاج في الدول المنتجة، والتقييدات في استثمارات التنقيب والتكرير. أما الجانب الآخر من المعادلة فهو تباطؤ الطلب العالمي، خصوصًا من آسيا وأوروبا، والذي قد يدفع الأسعار إلى ما دون 50-55 دولاراً للبرميل.
في ظل هذا السياق المتقلب، فإن أي قفزة تفوق 100 دولار قد تُسجِّل انعطافة خطيرة نحو التضخم، وتُلزم البنوك المركزية بإعادة تقييم برامجها، مما قد يؤدي إلى تجميد في السيولة وضرب النمو.
الدول المصدّرة في مرمى الطلاق المالي
الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية — سواء في الشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا — هي الأكثر عرضة لصدمة هبوط الأسعار. فجأة، تنخفض مواردها، وتتفكك موازناتها، وتتصاعد احتمالات العجز والديون.
النتيجة؟ تلك الدول تخرج من دائرة الاستقرار المالي وتُصبح نقطة توتر في النظام العالمي، يُحتمل أن تتسع إلى أزمة إقليمية أو حتى انتقال العدوى إلى الأسواق المالية الكبرى.
النفط كعامل تشابك مالي
لن يُبقى النفط محدودًا بدوره كمُنتَج سلعي؛ بل إنه صلة وصل بين الأسواق المالية والدول والشركات والأفراد. حركة حادة في أسعاره قد تدفع المستثمرين للفرار من فئات معينة إلى أخرى، فتنهار بعض الأصول وترتفع أخرى، ويُعيد المستثمرون توازن محافظهم بسرعة مخيفة.
في هذا السياق، يصبح النفط ليس مجرد وقود، بل مؤشراً مُنبهاً لئن تنبيهات المباشرة: إذا اهتزّ النفط، فقد يُجرّ النظام المالي برمته.
ثالث البؤر: فقاعة الأصول الرقمية — الخطر الصامت
العملات المشفرة: الجاذب الخطر
لطالما نظر إليها كثيرون على أنها “الملاذ الرقمي”، لكن العملات المشفرة مثل البتكوين والإيثريوم ليست إلا مناطق قنابل موقوتة. من جهة، يشهد البتكوين ارتفاعًا مذهلاً في القيمة، مع دخول صناديق استثمارية جديدة وكثرة المضاربات.
لكن من جهة أخرى، تقلباتها الحادة، وعدم وجود دعم مؤسسي ثابت، والاعتماد على الثقة الجماعية تجعل منها سمة مخاطرة لا يُستهان بها. في لحظة، قد تنقلب المكاسب إلى خسائر هائلة في ساعات معدودة، إذا ما اصطدمت بتصحيح أو أزمة ثقة.
الأصول الرقمية والتشابك مع النظام المالي
الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية في بعض الدول بدأت بالفعل في النظر إلى الأصول الرقمية كجزء من النظام المالي، ما يعني أن أي انهيار فيها قد يتسلّل إلى القطاعات التقليدية بطرق غير متوقعة.
علاوة على ذلك، فإن التداول بالرافعة المالية والتوسع في منتجات المشتقات القائمة على العملات الرقمية يُضاعف المخاطر. فحتى لو كان حجمها النسبي في الاقتصاد الكلي لا يزال محدودًا، فإن الشكوك في استقرارها قد تؤدي إلى عدوى سيولة أو بانكوك في مؤسسات مالية قائمة على الربط بين الفضاء الرقمي والمالي التقليدي.
هل تخفي الفقاعة رقماً كبيراً تحت غطاء اللامحدودية؟
قد لا تظهر الأزمة الرقمية في البداية كزلزال مفاجئ، بل كهبوط تدريجي، ثم تصحيح حاد، ثم موجه انهيار تجتاح معه الثقة من منصة إلى منصة، ومن مستثمر إلى آخر.
إذا انكسر الحاجز النفسي الجماعي بين المستثمرين، قد يُصبح الانهيار السريع في الأصول الرقمية نقطة البداية في هزة تستهدف أسواق الأسهم، جهات التمويل الجديدة، وربما البنوك التي دخلت هذا الحقل.
تشابك المراكز، وتفجير الشرارة: كيف يلتقي الثلاثي في لحظة مصيرية؟
لا نعيش في صندوق مغلق حيث كل بؤرة تعمل بمعزل. بل إن النظام المالي معقد، مترابط، وغير ثابت. وهنا بعض السيناريوهات التي قد تظهر فيها الهزّة الكبرى:
- بيع السندات الأميركية من جهة اليابان أو الصين يقود إلى ارتفاع عوائد السندات الأميركية، ما يضغط على الحكومات ذات الديون الهائلة ويزيد من المخاطر المالية في الدول النامية، فتضطر البنوك إلى سحب السيولة، ما قد يفاقم الأزمة في أسواق الطاقة أو يضغط على أصول المضاربة.
- قفزة ضخمة في أسعار النفط ترفع معدلات التضخم عالمياً، تجبر البنوك المركزية على رفع الفائدة أو التمسك بمعدلات مرتفعة، فتتراجع السيولة، ويبدأ المستثمرون بالهروب من الأصول عالية المخاطرة، بما في ذلك الأصول الرقمية.
- انهيار في سوق العملات الرقمية يُحدث موجة ذعر في قطاع التمويل، خصوصًا إذا امتدّ إلى كيانات تدمج بين التمويل التقليدي والتقنيات الحديثة، ما قد يدفع إلى سحب كبير من الأصول الأكثر تقلبًا، ثم يمتد إلى أسواق الأسهم والعقارات.
في اللحظة التي تلتقي فيها الشروط — تصفية ضخمة في السندات، صدمة نفطية قوية، وهبوط في العملات الرقمية — قد نحصد الزلزال الأعظم الذي لطالما حذّر منه الاقتصاديون.
أي السيناريوهات الأقوى؟ قراءة في الاحتمالات والعواقب
الأرجح؟ الأزمة في الدين السيادي — والآخران مرافقة
إذا اضطرّت اليابان أو الصين إلى تعديل مخصصاتها من السندات الأميركية فجأة، فإن الحريق قد يبدأ هناك. فالديون السيادية هي الأساس الذي يُبنى عليه هيكل التمويل العالمي، وأي تهدّم فيه قد يُسبب انهياراً في ثقة النظام برمته.
السيناريو البديل: شرارة نفطية تقود الانفجار
قد تُشعل مواجهة جيوسياسية أو قطع إمداد مفاجئ في الشرق الأوسط أو الشرق الأقصى أو القطب الشمالي موجة صعود في أسعار النفط، فتدفع التضخم إلى القفز، وتضع البنوك المركزية في زاوية صعبة. في هذه اللحظة، قد تنكسر الأسواق المرهفة من الضغوط، ويبدأ التأثير الشرطي على الأسهم والدول النامية.
السيناريو الأشد فتكًا: انهيار الأصول الرقمية كحاضنة للذعر
قد يبدو السيناريو الأكثر دراماتيكية هو انهيار العملة الرقمية الكبرى، في وقت يُدخل فيه كثير من المؤسسات والمستثمرين في اللعبة. إذا انهار البتكوين أو غيره بضربة قوية، فإنها قد لا تبقى حبيسة القطاع التكنولوجي، بل تمتد عبر السيولة، الضمانات، نكوص الثقة، فيضرب قطاعات اقتصادية لم تكن تُتصوَّر جزءًا من “كربكتوماني” العملات الرقمية.
التأثيرات المحتملة: من الكساد إلى إعادة الهيكلة الكبرى
- ارتفاع تكاليف الاقتراض، وضغط على النمو العالمي.
- ارتفاع حالات تعثر الحكومات أو المؤسسات ذات المديونية العالية.
- هجرة استثمارية إلى الملاذات (الذهب، الدولار، السندات الآمنة).
- تغير في هيكل الاقتصاد العالمي: دول قد تفقد القدرة على التمويل، مؤسسات تنهار، ومنافسات جديدة تنشأ في التمويل غير التقليدي.
- تسريع الاتجاه نحو التنظيم المالي العالي الرقابة، وربما ولادة هيكل مالي جديد أقل اعتماداً على دين السيادية أو أصول أكثر مقاومة للتقلبات.
كيف نستعد؟ سياسات، وقائية، ومقترحات استراتيجية
تصويب السياسات المالية والالتزامات الدينوية
- ضرورة تبنّي الحكومات الكبرى مسار خفض تدريجي للدين، مع التركيز على النمو المستدام وليس التوسع المكيّف فقط.
- تعزيز الشفافية في إدارة الدين وسياسات التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية.
- تجنب المفاجآت في التنصل أو إعادة جدولة الديون، وهو ما يدمّر الثقة العالمية.
تنويع مصادر الطاقة والدعم الاستراتيجي
- الدول المنتجة للطاقة يجب أن تسعى لتوسع اقتصادي غير معتمد كلياً على النفط، وتحويل فائض الإيرادات إلى صناديق الاستقرار.
- الاستثمار في التقنيات البديلة للطاقة، والاعتماد على مزيج مستدام من الطاقات المتجددة لتخفيف الصدمة في حال تقلبات أسواق النفط.
تنظيم الأصول الرقمية بحذر وتوازن
- وضع أطر تنظيمية واضحة للعملات الرقمية، تحكم التوسع في الرافعة المالية، وتشترط متطلبات سيولة وضمانة.
- العمل مع البنوك والمؤسسات المالية لخلق جسور مؤسسية آمنة بين النظام المالي التقليدي والعملات الرقمية.
- تشجيع الابتكار الرقمي المشروط بضوابط مرنة تتيح النمو مع السيطرة على المخاطر.
بناء شبكات استقرار مالي عالمي
- تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة الأزمات العابرة للحدود.
- إنشاء صناديق تخفيف صدمات طارئة دولية لدعم الدول المتضررة أو الأسواق الضعيفة في لحظة الهزّة.
- تشجيع التعاون المالي وتقاسم المعلومات لتقليل المفاجآت المفاجئة.
الزلزال ليس مفاجئًا، لكنه قد يكون المدوّي
إن ما نعيشه اليوم ليس مجرد مرحلة من التذبذب المؤقت، بل هو استعداد لزلزال محتمل في النظام المالي العالمي. المعادلة ليست متوازنة: ديون هائلة، طاقات متقلبة، وأصول رقمية متوّهجة — ثلاث مراكز توتر يمكن أن تتحول إلى ابتداء كارثة عالمية.
عواقب هذا الزلزال قد تكون مأساوية، لكن ليس من الحكمة أن نكون ضحايا المفاجأة. البدء بالتوعية، التحضير، وتبني السياسات المرنة والمتوازنة هو أولى خطوات النجاة. في هذا العدد الخاص، نوجه الدعوة إلى صناع القرار والمستثمرين والقارئ العادي أن يدركوا أن القادم ليس محتملاً، بل وارد قوي، وأن السؤال الحقيقي هو: هل نكون جاهزين؟